أما
ما هو أسوأ من ذلك كله، فهو أن أحداً ممن هم «فوق» لم يخرج ليخبر من
أصابهم الهلع ما هي القطاعات غير المشمولة بحال الطوارئ الصحية. «لا داعي
للهلع». عبارة جاءت متأخرة كثيراً، ولن تكون ارتداداتها على عدّاد الإصابات
خلال الأيام المقبلة ذات تأثير، لأننا على الأرجح سنكون أمام سيناريو
لبناني بامتياز. لا إيطالي ولا إسباني. رعب هذا السيناريو أن النظام
الاستشفائي فُقد فيه أيّ مقومات للصمود.
مُقارنةً مع أجواء الحزم
التي أشاعتها مقررات اللجنة الوزارية المخصصة لمواجهة كورونا لجهة إقفال
المطار وحظر التجول التام والإقفال الشامل لمختلف القطاعات كالمؤسسات
الغذائية والسوبرماركات والصيدليات والأفران وغيرها، بدت مُقرّرات المجلس
الأعلى للدفاع، ليل أمس، «باهتة»، خصوصاً بعد الذعر الكبير الذي سبقها،
وتمثّل في التهافت على محال بيع المواد الغذائية والأفران للتموّن عن إقفال
الأيام السبعة أيام.
تعديلات عديدة أدخلها المجلس الأعلى للدفاع على
مقررات اللجنة الوزارية أصابت جوهر طابعها «الحديدي»؛ لا إقفال للمطار ولا
إغلاق كاملاً للأفران ولمُؤسسات بيع المواد الغذائية وأسواق الخضار واللحمة
والسمك بالجملة وغيرها. ما أُعلن كان بمثابة «تشديد» إجراءات مرحلة
الإقفال القائمة منذ السابع من الشهر الحالي أصلاً، عبر إلغاء الاستثناءات
التي كانت ممنوحة لبعض المؤسسات العامة والبلديات ومحال الميكانيك ومشاتل
الزهور، فضلاً عن تقييد حركة السيارات واقتصار تجوّل المُقيمين غير
المُستثنين من القرار (دبلوماسيين وعسكريين وعاملين في القطاعات المُستثناة
والصحافيين وغيرهم) بهدف تبضع حاجاتهم الأساسية أثناء دوامات حددها المجلس
(كالأفران من الثامنة صباحاً حتى الثالثة بعد الظهر ومحطات المحروقات من
الخامسة صباحا حتى الخامسة مساءً...). واستبدل المجلس خيار الإقفال التام
للمطار بتقليص عدد الوافدين إليه إلى 20% من قدرته الاستيعابية (نحو ألفي
مُسافر)، فيما فُرض على الوافدين من خمس مدن (القاهرة، أضنة، بغداد،
اسطنبول وأديس أبابا) الحجر الإلزامي لمدة 7 أيام في فنادق على نفقتهم
الخاصة، على أن يتم إجراء فحوصات مخبرية لهم مرتين، الأولى لدى وصولهم إلى
المطار والثانية في اليوم السادس لإقامتهم. أما الوافدون من بقية البلدان،
فيخضعون لحجر إلزامي لمدة 72 ساعة في الفنادق التي تضمنتها لائحة وزارة
السياحة.
المُشكلة لم تعد محصورة بعدد الأسرّة بل بنقص الطواقم والكوادر الطبية
صحيح
أن وقع هذه المقررات نفّس حال الخوف الكبيرة التي خلّفها خبر الإغلاق بسبب
تفاقم الواقع الوبائي، إلا أن أنه يخشى أن تكون بمثابة تراجع عن حالة
التأهب القصوى التي يفرضها وضع الفيروس الذي سجّل أمس أكثر من ثلاثة آلاف
إصابة من أصل نحو 12 ألف فحص فقط (أي نصف معدلات الفحوصات التي تجرى في
بقية أيام الأسبوع)، ما يعني أن الأرقام لا تزال مقلقة، وهي ماضية نحو
الارتفاع مع استئناف ارتفاع أعداد الفحوصات المخبرية.
«البرودة» انسحبت
بدورها أيضاً على القرار الذي روّج له المكتب الإعلامي لوزير الصحة ليل أول
من أمس بإخلاء المُستشفيات الحكومية من المرضى وتخصيصها لمصابي «كورونا».
فبحسب مدير العناية الطبية في وزارة الصحة الدكتور جوزف الحلو، القرار لا
يزال «فكرة تجري بلورتها»، مُستبعداً المباشرة فيه فوراً، فيما أشار رئيس
مصلحة المُستشفيات في الوزارة جهاد مكوك الى أن القرار لا يُنفّذ بـ«كبسة
زر»، إذ إن هناك شقاً بالغ الأهمية يتعلّق بنقل الحالات المقيمة في غرف
العناية الفائقة والحالات الحرجة، وهو ما يتطلب وقتاً. ولفت مكوك الى أن
المُشكلة حالياً «لم تعد محصورة بعدد الأسرّة، بل بنقص الطواقم والكوادر
الطبية المدربة. وعلينا العمل على تغطية هذا النقص عبر وضع آلية حوافز».
يعني
ذلك، عملياً، أن التعويل لا يزال مجدداً على المُستشفيات الخاصة، «خصوصاً
تلك التي تملك إمكانيات كبيرة تخولها افتتاح أقسام لكورونا بسرعة»، بحسب
مكوك. وهو ما يعني العودة، بشكل أو بآخر، إلى نقطة البداية، حيث يبقى صنّاع
القرار عالقين في النقاشات وتحديد الآليات بـ«المفرق» لتدارك إدارة الأزمة
التي تأكل القطاع الاستشفائي.
أجهزة التنفس من مريض إلى آخر!
ثمة وجوه كثيرة لتأثيرات انهيار القطاع الاستشفائي على صحة المُقيمين. فإلى العجز عن إسعاف بعض الحالات بسبب الضغط على الأسرّة، تبرز تداعيات المُشكلة الاقتصادية على نوعية الخدمات الصحية التي يتلقاها المريض. وتُفيد معلومات «الأخبار» بأن بعض المُستشفيات يضطر مثلاً، بفعل الأزمة، إلى استخدام معدات ومُستلزمات طبية مخصّصة للاستعمال مرة واحدة لأكثر من مرة بعد تعقيمها، علماً بأن تعقيم بعض المعدات لا يُخلّصها من «آثار» المريض السابق. والأخطر هنا هو إعادة استخدام بعض المعدات الموصولة على أجهزة التنفس، ما يسبّب حُكماً تداعيات خطرة، وفق مصادر معنية باستيراد تلك الأجهزة.
في هذا الوقت، تستمر أسعار أجهزة تصنيع الأوكسيجن بالارتفاع في السوق السوداء بسبب انقطاعها ومحدودية كمياتها لدى الشركات، وقد تضاعف سعر بعضها ثلاث مرات (الأجهزة الصينية من 400 دولار إلى 1200، والأوروبية من 800 دولار إلى 2500).






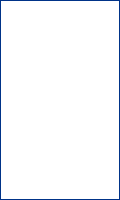




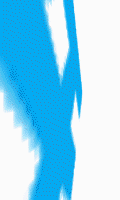
.gif)