فمنذ
فضيحة الجيش الأميركي في تعذيب المعتقلين داخل جدران أبو غريب العراقي
ومعتقل غوانتنامو، لم يُصَبْ الأميركيون بهذا العري الأخلاقي أمام شعوب
العالم كما أصيبوا خلال الأيام المنصرمة.
الصرخات الشعبية والرسمية ومن
هيئات أممية لرفع الحصار عن سوريا، وهول المشاهد التي نقلت جزءاً قليلاً من
واقع الكارثة على الأرض، كانت أعلى من البروباغندا الأميركية ومن وسائل
الإعلام القطرية وبعض الغربية، التي حاولت التعمية على حقيقة تأثير
العقوبات الأميركية/ الغربية على ذلك البلد. لعل الجرأة التي تحلّت بها بعض
الدول العربية الخاضعة للفلك الأميركي، والحالة الشعبية في العالمين
العربي والإسلامي وفي أوساط الجاليات السورية والعربية في الدول الغربية،
نبّهت الأميركيين إلى أنه لن يكون لديهم القدرة والذرائع الكافية على إيقاف
كرة التضامن العالمي المعنوي ــ على الأقل ــ مع سوريا، وإلى أن سيف
العقوبات المصلت على رقاب الكوكب، قد ينكسر أمام الرأي العام العالمي،
فيشكل النموذج السوري مدخلاً لخسارة الولايات المتّحدة أكثر أدواتها
فعاليةً في إخضاع الشعوب
الارتباك الذي سبق القرار ظهر بوضوح خلال الأيام الماضية، في محاولات المسؤولين الأميركيين التملّص من حصار سوريا، ولا سيّما ظهور الناطق باسم الخارجية الأميركية في الشرق الأوسط على الإعلام العربي، وتحدثه بالعربية من أجل تلميع الموقف الأميركي، بعدما كان وجود المنصب والشخص مجهولاً بحدّ ذاته للكثيرين. في الشكل، بدا إصدار القرار اعترافاً سياسياً وحسيّاً جديداً بدور الولايات المتحدة في حصار الشعب السوري والدولة السورية بذريعة محاسبة «النظام»، مع مسؤولية أميركا عن هذه السياسة الكارثية على مستقبل الدولة والمجتمع والوطن. أمّا في المضمون، فإن أخطر ما يكون هو تقديم القرار كخطوة حقيقيّة في إطار رفع العقوبات التي تطال الدولة بكلّ مؤسساتها، وتحاصر قطاعات الطاقة والنقد والمواد الصلبة والتكنولوجيا، وبدرجة أقلّ، ظاهراً، قطاعات الدواء والغذاء والتعليم.
لا يغيّر قرار الخزانة الأميركية الكثير على أرض الواقع. فهو، في مادته الأولى يشير إلى استثناء ما يسمّيه «تعاملات جهود الإغاثة من الزلزال التي تطالها قرارات العقوبات على سوريا»، من دون أن يحدّد ماهية هذه التعاملات، ليعود ويشير في الجزء الأخير إلى أن الاستثناء لا يشمل الجهات الخاضعة للعقوبات الأميركية، ولا سيّما الحكومة السورية ومؤسساتها، ما يبقي الشركات والجهات المختلفة في حالة من القلق لناحية التعامل مع الجهات السورية، خشية المزاجية الأميركية في تحديد التعاملات، كما الخشية من اتخاذ إجراءات في السنوات المقبلة بذريعة التعامل مع دمشق.
قرار الخزانة الأميركية أمس لا يصلح إلّا لإغراق سوريا بصناديق الإعاشة
أزمة
سوريا قبل الزلزال وبعده، لا يمكن اختصارها بعمليّات إنقاذٍ قصيرة المدى
لضحايا الكارثة وتقديم سلل الغذاء والدواء والبطانيات، أو حتّى إعادة إعمار
وترميم ما تهدّم في هذه الواقعة الطبيعية تحديداً، لأن القيام بهذا الدور
وحسب، يتطلّب في أدنى مستوياته مقوّمات دولة تتوفّر فيها الطاقة والوقود
والآليات والفرق المجهّزة بشريّاً ومادياً.
في تشرين الثاني الماضي،
وثّق تقرير المقررة الخاصة للأمم المتحدة حول تأثير العقوبات أحادية الجانب
على سوريا، النتائج الكارثية على الشعب السوري، ليتوصل في خلاصته إلى أن
هذا البلد يموت بسرعة. كيف يمكن أن تحصل عمليّات الإنقاذ ورفع الأنقاض إن
كانت سوريا تفتقر إلى المعدات الثقيلة؟ فالعدد الكبير من المعدات التي كانت
تملكها قبل الحرب انخفض حتى النصف، ولم تتمكن الحكومة أو القطاع الخاص من
شراء أخرى جديدة بسبب الحصار وفقدان الأموال الكافية، ولا تتمكن اليوم من
تجديد ما تبقّى من الأسطول الذي يطاله القدم ويفتقر إلى الصيانة الكافية
وقطع الغيار اللازمة. كيف يمكن معالجة الحالات الحرجة من الجرحى والاستمرار
في تقديم العناية الطبية لملايين السوريين في ظلّ الحاجة إلى المعدّات
الطبية والأدوية؟ إذ إن الحصار على قطاع التكنولوجيا ودمار الكثير من
المستشفيات خلال الحرب أصابا قطاع الاستشفاء السوري بالشّلل، من دون القدرة
على تعويض الخسائر أو تجديد المعدات الموجودة أو تطويرها، فضلاً عن
الخسائر الهائلة في سلاسل إنتاج الدواء. وكيف يمكن لآليات الإسعاف مثلاً
التحرك من دون الوقود الكافي؟ أو الآليات إن وجدت؟
كلّ هذا لا يضاهي تأثير العقوبات الأميركية على قطاع الطاقة، المستثنى أصلاً من «الاستثناء» الأخير.
التجارب الأميركية في فرض العقوبات على الدول التي لا تخضع لإرادة واشنطن السياسية، والشعوب التي تملك الموارد وتتمرّد على الهيمنة الأميركية وأدواتها، أكسبت الأميركيين خبرة في خنق الاقتصادات وتحطيم الدول عبر فرض الحظر على قطاعات وسلعٍ معيّنة، تعيق حركةً اقتصادية بأكملها وتعطّل منشآت ومشاريع لمجرّد حظر بعض مكوناتها. ألا تحتاج أعمال الإنقاذ والسوريون بشكل عام إلى الكهرباء مثلاً؟ فبعيداً عن محطات الكهرباء التي أصيبت خلال الحرب بأضرار كبيرة أو دمّرت بالكامل ولا يمكن ترميمها، هناك أكثر من محطة حرارية متوقّفة عن العمل بسبب الحصار بشكل مباشر. محطة حلب لإنتاج الكهرباء على سبيل الذكر، لديها قدرة على توليد 1 غيغا واط من الكهرباء، متوقّفة عن العمل بسبب الحاجة إلى صمامات جديدة، لا تنتجها سوى دول معيّنة، وروسيا ليست من ضمنها، وهذه الدول وشركاتها تمتنع عن تزويد سوريا بها، بسبب العقوبات الأميركية. وكذلك الأمر بالنسبة إلى محطة تشرين الحرارية في دمشق، التي تنتج 2 غيغا واط وتكفي لسدّ حاجة كامل المدينة، لكنها أيضاً متوقّفة عن العمل بسبب تلف الصمامات وقطع غيار أخرى ممنوعة عن البلاد.
قرار الخزانة الأميركية أمس، لا يصلح إلّا لإغراق سوريا بصناديق «الإعاشة»، أي ما يكفي لكي لا يموت السوريون دفعةً واحدة، بل بالموت البطيء. وفي الأشهر المقبلة، لن يكون القرار سوى مادة إعلامية أميركية لتعميم اليأس في هذا البلد، وتحميل الحكومة السورية مسؤولية ما سيأتي من مآسٍ، بذريعة أن العقوبات مرفوعة عن دمشق، لكن لم يتغيّر شيء!






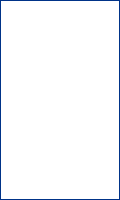



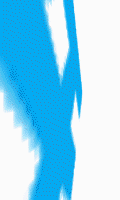
.gif)